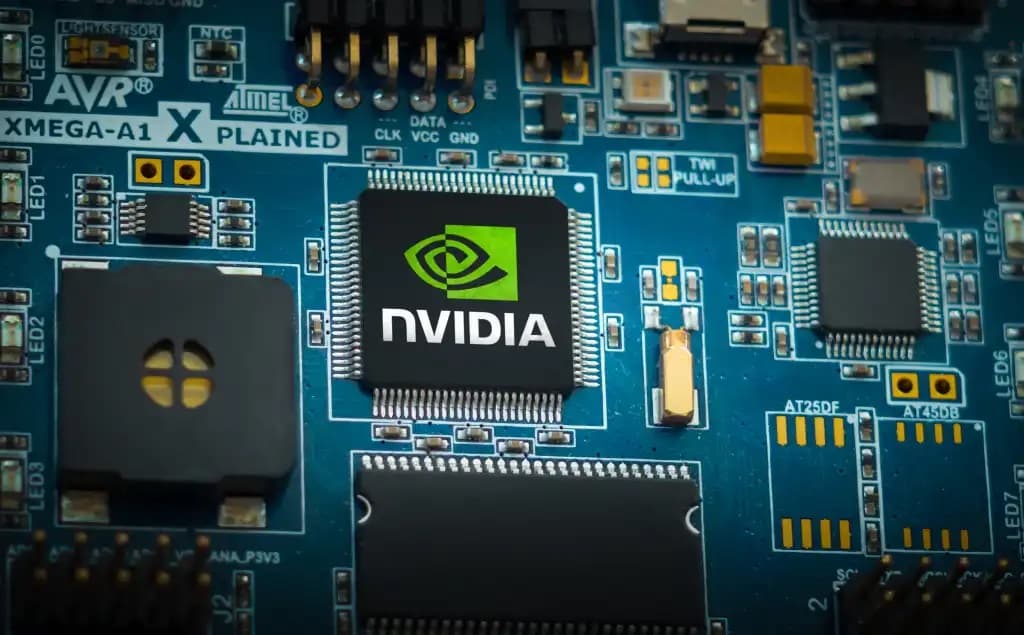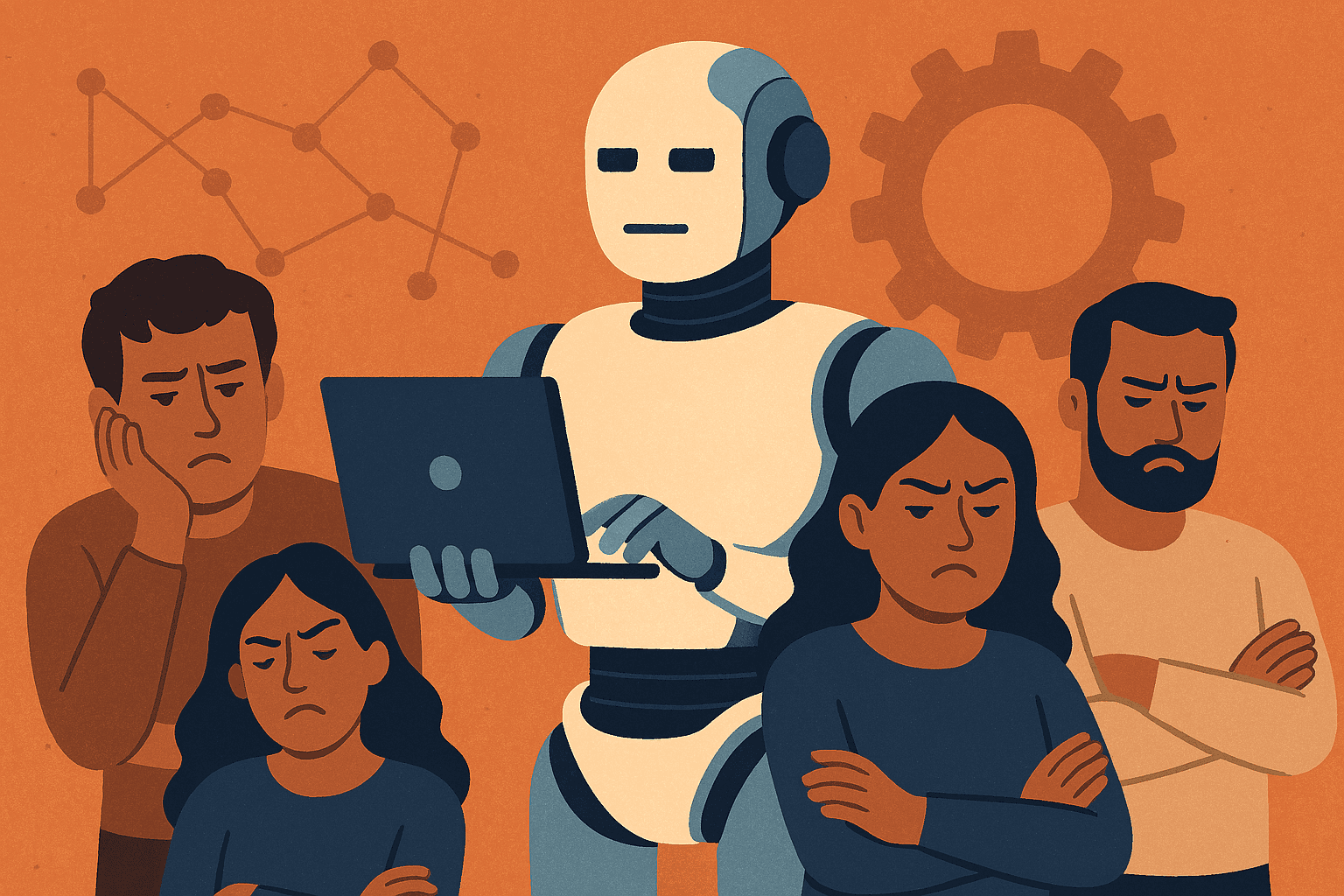أزمة عالمية في رقائق الذاكرة... فما الحكاية؟

لو أن شخصاً استثمر مدّخراته قبل عام واحد فقط في بضع منصّات من رقائق ذاكرة الحواسيب، لكان اليوم قد ضاعف أمواله على الأقل، مع توقّعات بمزيد من الارتفاع الحاد في الأسعار خلال الأشهر المقبلة. هذا ما تكشفه معطيات نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير موسّع عن واحدة من أسرع السلع التكنولوجية ارتفاعاً في القيمة على مستوى العالم.
يقف خلف هذا الارتفاع الطلب الهائل من شركات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى كميات ضخمة من رقائق الذاكرة، سواء ذاكرة الوصول العشوائي «رام» أو رقائق التخزين المعروفة بالفلاش أو الذاكرة الصلبة. هذه الرقائق لا تُستخدم فقط في مراكز البيانات العملاقة، بل تدخل في تصنيع معظم الأجهزة الرقمية في العالم، من الهواتف والحواسيب إلى السيارات والتلفزيونات. ورغم هذا الانتشار الواسع، فإن أكثر من تسعين في المئة من إنتاجها العالمي يأتي من ثلاث شركات فقط هي «إس كيه هاينكس» و«سامسونغ» و«مايكرون»، بحسب ما أوردته وول ستريت جورنال.
ووفق بيانات شركة «كاونتربوينت ريسيرتش» التي نقلتها الصحيفة، قفزت أسعار رقائق الذاكرة بنحو خمسين في المئة خلال الربع الأخير من عام ألفين وخمسة وعشرين، مع توقّعات بارتفاع إضافي يتراوح بين أربعين وخمسين في المئة مع نهاية الربع الأول من عام ألفين وستة وعشرين. ويعود ذلك أساساً إلى الطلب غير المسبوق من مشغّلي مراكز البيانات، المستعدين لدفع علاوات سعرية مرتفعة لتأمين احتياجاتهم.
هذا الضغط المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي بدأ يزاحم باقي القطاعات الصناعية، ما ينذر بتداعيات واسعة قد تمتد إلى تأخير إنشاء مراكز بيانات جديدة، وارتفاع أسعار الحواسيب المحمولة وأجهزة التلفاز وسائر الإلكترونيات الاستهلاكية، إضافة إلى احتمال تجدّد أزمة نقص الرقائق في قطاع السيارات، بما قد يؤدي إلى تأخير إنتاج المركبات، في مشهد يعيد إلى الأذهان أزمة سلاسل التوريد خلال جائحة كورونا، وفق تحليل وول ستريت جورنال.
وتنقل الصحيفة عن أفريل وو، نائبة رئيس الأبحاث في شركة «ترندفورس» المتخصّصة في تتبّع صناعة أشباه الموصلات ومقرّها تايبيه، قولها إنها تتابع قطاع الذاكرة منذ قرابة عشرين عاماً، لكنها لم تشهد ظرفاً مشابهاً لما يجري اليوم، واصفة المرحلة الحالية بأنها «الأكثر جنوناً على الإطلاق».
حتى وقت قريب، كان محللون يتوقّعون أن يشكّل نقص الطاقة الكهربائية العائق الأكبر أمام بناء الحواسيب العملاقة الخاصة بالذكاء الاصطناعي بعد عام ألفين وستة وعشرين، بينما لم تكن أزمة الذاكرة ضمن السيناريوهات الرئيسية. إلا أن التطورات الأخيرة، بحسب وول ستريت جورنال، غيّرت هذا التقدير جذرياً.
فشركة «سامسونغ» كانت قد أبطأت قبل عامين وتيرة بناء مصنع جديد لإنتاج رقائق الذاكرة بسبب تراجع الطلب العالمي، لكنها عادت في أواخر عام ألفين وخمسة وعشرين إلى تسريع استكمال المشروع، وبدأت بتوسيع الطاقة الإنتاجية في مصانع قائمة. أما «إس كيه هاينكس»، المتصدّرة عالمياً في هذا القطاع، فأعلنت في شهر تشرين الأول الماضي أنها باعت كامل إنتاجها المخصّص لعام ألفين وستة وعشرين، بالتوازي مع خطط استثمار ضخمة في طاقات تصنيع جديدة، يُفترض أن تُموَّل من عائدات قياسية.
من جهتها، شهدت شركة «مايكرون» الأميركية، ومقرّها بويزي في ولاية أيداهو، زيادة كبيرة في طلب عملائها من مراكز البيانات على منتجاتها للأعوام ألفين وستة وعشرين وألفين وسبعة وعشرين، وفق ما صرّح به كبير مسؤولي الأعمال في الشركة سوميت سادانا لصحيفة وول ستريت جورنال. وإلى جانب ذلك، سجّلت الشركة نمواً ثابتاً في الطلب من باقي القطاعات، مع اتجاه المصنّعين إلى زيادة كميات الذاكرة في أجهزتهم. وقد أعلنت «مايكرون» أخيراً وقف إنتاج علامتها الشهيرة من ذاكرة الحواسيب الشخصية، للتركيز على تزويد السوق بذاكرة متقدّمة مخصّصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي خطوة تعكس حجم الرهانات المستقبلية، وضعت «مايكرون» في نهاية الأسبوع الماضي حجر الأساس لما وصفته بمجمّع صناعي عملاق بقيمة إجمالية قد تصل إلى مئة مليار دولار أميركي في مقاطعة أونونداغا بولاية نيويورك. ويتكوّن المشروع من عدة مصانع سيتم تشييدها على مدى عشرين عاماً، وجميعها مخصّصة لإنتاج رقائق الذاكرة.
غير أن هذا الاستثمار الضخم لن يخفّف الأزمة قريباً، إذ تشير تقديرات «ترندفورس»، التي نقلتها وول ستريت جورنال، إلى أن معظم هذه الطاقات الجديدة لن تدخل الخدمة قبل عام ألفين وسبعة وعشرين، ولن يكون لها تأثير فعلي في توازن العرض والطلب قبل عام ألفين وثمانية وعشرين. وحتى ذلك الحين، تعمل المصانع الحالية بأقصى طاقتها، وهي مصانع بُني معظمها قبل طفرة الذكاء الاصطناعي بسنوات.
ويختصر سادانا المشهد بالقول إن الشركة تتوقّع وضعاً صعباً في تلبية طلبات العملاء خلال المستقبل المنظور، في إشارة واضحة إلى أن أزمة رقائق الذاكرة مرشّحة للاستمرار، مع ما تحمله من أعباء إضافية على الاقتصاد العالمي والمستهلكين على حدّ سواء، كما خلص تقرير وول ستريت جورنال.